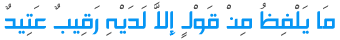مصادر تكوين القيم
مصادر تكوين القيم يرى الكثير من الباحثين أن العامل الحاسم الذي له دور كبير في توجيه السلوك إنما هو المكون الثقافي، والذي هو الناتج الطبيعي والثمرة المرَّة أو الحلوة للمكون العقدي.
وعلماء التربية وعلماء النفس وعلماء الاجتماع يقررون بأن رؤية الإنسان لذاته ودوره ورسالته، ورؤيته للبيئة المحيطة، وكذلك رؤيته للكون والحياة، تتشكل من خلال مصدرين اثنين، هما:
1. العقيدة التي يعتقدها الإنسان ويدين بها.
2. الثقافة التي تربى عليها، وتَكوَّن عقلُه ووجدانُه من خلالها.
ولنا مع المصدر الأول والذي هو العقيدة وقفة تأمل وتحليل..
فمن المعروف علميًّا أن القيمة عندما تستمد قداستها من العمق الديني، فإن حرية ممارستها تنبعث من أقوى المشاعر تأثيرًا في حياة الإنسان، فمن حيث التوصيف والرصد: تشكل العقيدة الدينية مكونا أساسيا في خلقة الإنسان وجبلته، يعبر عنها بأنها فطرة أصلية في النفوس البشرية، لا يغني عنها قانون ولا فلسفة ولا تثقيف.
ومهما قيل عن أثر الإيمان بمبدأ ما أو بعقيدة ما في حياة الإنسان ولو كانت من وضع البشر ومن بنات أفكارهم، إلا أن عقيدة الإسلام تختص عما دونها من العقائد بما لها من آثار جليلة الوقائع، كبيرة النفع في الحياة بجوانبها المتعددة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ذلك لأن العنصر البشري يبقى قبل كل العناصر وبعدها هو الأساس في بناء الحضارات ورقي الأمم وسيادة القيم، وذلك بنمط السلوك الذي يسلكه وفق ما يعتقده من عقيدة يدين بها التزامًا، ويدين لها في تقدمه أو تأخره، في علمه أو جهله، وحتى في سموه، أو هبوطه وتدنيه.
ومن حيث التحليل والتعليل:
لا توجد عقيدة ربطت بين الدنيا والآخرة، ومزجت بين عالم الغيب وعالم الشهادة، ونظمت علاقات الأفراد والمجتمعات والأمم، مثلما فعلت عقيدة الإسلام في حياة المؤمنين، وقد يتبادر إلى الأذهان أن الدين كله شيء واحد وأنه مجرد تصور غيبي يفلسف الوجود، وأن آثاره في واقع الحياة واحدة رغم تباين أشكال الشعائر وأنواع التعاليم.
يقول الدكتور حسن الترابي في كتابه الإيمان: والحق أن رسالات الله كلها يجمعها نوع من التوافق العام في الأصول الأولى، وأن المرسلين جميعًا أخوة عقيدة واحدة، انبعثت من مشكاة واحدة، يصدق بعضها بعضا، ولكن عوامل الوضع وتقادم الزمان اخترقت أصول العقيدة الصحيحة فتلاشت معانيها واختلط وحي السماء بتعاليم البشر بفضل الوضاعين، ولم يبق من أصل الدين إلا بقية انقطعت صلتها بالسماء وأضحت نوعًا من التقاليد الموروثة تتغير وتتبدل بعوامل الابتداع وفق ما يراه كهانه، ومن هنا يتضح لنا أن الحديث عن الدين لابد أن يقيد بوصف الإسلام، ولا يساق على سبيل الإطلاق، لأن الإطلاق يحدث خلطًا بين ما هو صحيح من الدين وبين ما هو من وضع البشر بفعل التغيير والتبديل نتيجة المنافع والأهواء، كما جاء في النص الكريم (فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ) [البقرة: 79].
ولما كانت عقيدة الإسلام تحدث في النفس البشرية مجموعة من القيم، تتضمن تصورًا شاملا للدنيا والآخرة والحياة والموت، ويتسع هذا التصور ليدخل فيه أنواع النشاط الإنساني وتحديد العلاقات، من خلال الحق والواجب بين كل من الأطراف بما يضمن سلامة الفرد والمجتمع وما يتحقق من وفاق بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع، مما يكون له أبلغ الأثر في تحقيق قدرة الإنسان على أداء دوره ورسالته.
ولئن كان الحديث عن أثر العقيدة في تحقيق منظومة القيم يتطلب الإشارة إلى شعب الإيمان وما لها من تأثير فعال في تزكية النفس وتطهير المجتمع، إلا أن الحديث هنا يتطلب الإيجاز ويكتفى فيه بإشارات لبعض هذه الشعب اختصارًا للوقت وحتى لا تضيع منا معالم الأمور.
فالعقيدة الدينية تعتمد الحقائق الثابتة وتعطي للإنسان التصور الشامل الكلي الذي يربطه بقوى الكون من حوله ظاهره وباطنه، فيتولد لديه شعور بالعبودية لرب هذا الكون، ويشعر بنوع من المؤاخاة بينه وبين هذه القوى الكونية الكبرى، فيزداد طمأنينة وأمنًا، حيث يشعر أنه وهذه القوى يسيران في مسرى واحد ويتجهان لرب واحد، فلا يخاف غيره ولا يخشى سواه، ومن ثم يتحقق التوازن المطلوب في مضمون القيم، وتنتفي منه روح الصراع وأسبابه تلك التي تغلب على قيم المدارس الوضعية التى نشأت في ظل الانفصال عن الدين والتنكر لآثاره في تكوين والمجتمع.
يقول الأستاذ سيد قطب: "وقوة الثقة في الله، وهي العقيدة تفسر للفرد علاقاته بما حوله من الناس والأحداث والأشياء، وتوضح له غايته واتجاهه وطريقه وتجمع طاقاته وقواه كلها وتدفعها في اتجاه، كذلك قوتها قوة تجميع القوى والطاقات حول محور واحد وتوجيهها في اتجاه واحد تمضي إليه مستنيرة الهدف في قوة وثقة ويقين. والشخصية الإنسانية السوية وحدة متماسكة فهي في حاجة إلى عقيدة موحدة تصدر عنها في كل اتجاه، وتستلهمها في الشعور والسلوك وتستهديها في مواجهة الكون والحياة، وترجع إليها في كل صغيرة وكبيرة؛ لتكون نقطة ارتكاز تتجمع إليها خيوط حياتها ونشاطها فلا تتمزق ولا تتبعثر ولا يدركها القلق والحيرة والاضطراب، وكلما قويت هذه النقطة واشتدت صلاتها بالخيوط المنبثة هنا وهناك في حياة الفرد ونشاطه كانت شخصية أقوى؛ لأنها أكثر تجمعًا، وكانت خطواتها أهدى لأنها أوحد طريقًا".
ويؤكد الترابي أن منظومة القيم المتولدة من تلك العقيدة والصادرة عنها توضح للإنسان غايته، وتوضح له اتجاهه، وتفجر طاقاته وقدراته، وتوجهها وجهة تفيد ولا تضر وتعمر ولا تخرب وتبني ولا تهدم، "فلا جرم أن أصدق الحديث عن منظومة القيم ما كان منسوبًا إلى الإسلام؛ لأنه الدين الخالص ذو الأصول المحفوظة، ولأن سائر الأديان قد تبدلت عقائدها وشرائعها بما شابها من بدع شتى، ما أنـزل الله بها من سلطان، فالحديث في شأن الدين ينبغي ألا يساق على سبيل الإطلاق"
فالدين واحد في معانيه، تتكامل فيه ثلاثية العقيدة، والشريعة، ومكارم الأخلاق، وكل جانب من هذه الجوانب يؤدي وظيفة حيوية، وكأنه رافد يصب في مجرى نهر عام تلتقي كلها عند مصب عام، هو صياغة الإنسان الرباني وتشكيله وتزويده بالعقل المبدع الخلاق الذي يأبى الخرافة، وينأى عن السلوك وانحراف الأداء، كما تزوده بطهارة الخلق وتزكية النفس وتربي فيه القلب الكبير الذي يمتلئ بالمحبة ويعلو على الأهواء.
"فالعقيدة تدفع المؤمن لصالح الأعمال وتضبطه عن سيئاتها وتخط له معالم الخير والشر في الحياة. والشريعة بمبادئها العامة وأحكامها الفرعية هي دليل العمل ونظامه تبين اتجاهاته وأشكاله وترسم علاقاته وحدوده. فبالإيمان يستمد المرء قوته ويهتدي إلى وجهته في الحياة، وبالشريعة يتعلم أي نحو مفصل ينحو بعمله في واقع أحواله المعنية، كما يتعرف دقائق نظم السلوك وضوابطه. وما دام الإيمان واتباع الشريعة وجهين للدين متلازمين متكاملين، فإن الآثار الخيرة الناتجة عنهما في الحياة الدنيا يمكن أن ترد بحق لأي منهما. فالإيمان سبب في منافع الدنيا ومتاعها، لأنه معراج الروح وانشراح النفس أمام مسؤولياتها الضخمة في الحياة، فمن عمَّر قلبه بالإيمان بالله صفت نفسه واطمأنت وسمت عواطفها الإنسانية، وسارع إلى الخير وسابق إليه، وكان مشعل النور والهداية حيثما حل، مستقيمًا في الحق بعيدًا عن الهوى والأنانية والشح، فلا وجل ولا خيانة ولا غش ولا احتكار ولا أمعية ولا هدر للعقل ولا تقليد أعمى ولا امتهان للفكر ليسير وراء كل ناعق أو يتزلف لكل سيد، وإنما هو قلب خاشع ولسان ذاكر وعقل واع، يستوعب هداية الله وينطلق في ملكوت الله؛ ليكشف قوانينه فيه، ويسخره لعباده ليعمر الأرض، كما ينطلق في المجتمع الإنساني ليقيمه آمنًا مطمئنًا صافيًا نقيًّا مما يهدم الحياة ويروع الأحياء أو يخدرهم كما أكد ذلك الأستاذ عابد توفيق الهاشمي. قال تعالى: (فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ) [يونس: 98]. وبذلك تكون العقيدة الصحيحة -لا نقيضها- هي النبع والمصدر الأول للقيم الأخلاقية وللشعور بالالتزام بممارستها وتحويلها إلى نماذج تطبيقية متحركة ومتحققة في حياة الأمة أفرادًا وجماعات. ومن نافلة القول تكرار الحقيقة المعروفة لدى كل علماء النفس وعلماء الاجتماع أن أقوى أنواع الضبط للسلوك الإنساني هو الضبط الإرادي، وهذا الضبط لا يمكن أن ينتج إلا من الأخلاق التي ترتبط بقيم يدعمها الإيمان الجامع بها، وهي أخلاق لا تتبدل حسب الطلب، وإنما تبقى ثابتة، لأنها هي التي تحفظ للجماعة الحد الأدنى من التوازن، كما أنها تمد المجتمع بالقواعد التي تضبط سلوك الناس وتوجه ممارساتهم. تلك هي المصادر الأولية لكل قيم الحق والخير والجمال وتلك هي المؤثرات الأساسية التي تقف من خلفها في العقل والقلب والوجدان أولا، ثم تدفع بها إلى مجالات السلوك والممارسة، لتتحول واقعا معاشا في حياة الناس ثانيا.
• رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأسترالية للثقافة الإسلامية - أستراليا




 الخميس يناير 20, 2011 11:00 pm
الخميس يناير 20, 2011 11:00 pm