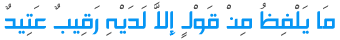قلم: أ. د. توفيق الواعي
للأمم طفولة كطفولة الأطفال، طفولة تصنعها الأمم لأنفسها، وترضاها لشخصيته؛ حيث تتصاغر إلى حد الاستقزام، وتتضاءل إلى حد البله، وتتدنَّى إلى حد المهانة، وهذه حالة مرضية، وعلة نفسية، تحتاج إلى طب ودواء، ونقاهة وشفاء، حتى تعود إليها طبيعتها، وترد إليها شخصيتها، ولكن المحيِّر الذي لا ينفع معه طب أو علاج؛ هو أن تتعامل هذه الأمم مع الأطباء والدواء بمنطق العداء، وبأسلوب الكاره للعافية والشفاء!.
وهذا ما يطلق عليه الكثيرون في بعض الأحيان "القابلية للاستعمار"، وأظن أن أمتنا اليوم تعيش في رحاب تلك الطفولة، ولله در القائل:
كنَّا الحصون بأرض الله شامخة فيها الحماة إذا عزَّ المحامونا
كنَّا الرياح إذ نادى الصريخ بنا كنَّا الرجاء إذا ضيمت أراضينا
كنَّا الجبال ثباتًا في مواقفنا كنَّا السماء سموًّا في معانينا
واليوم، وأي يوم هذا! لا نعرفه؛ حيث:
يميتنا الحزن تفكيرًا بحاضرنا ويبعث الهم عصرًا من مآسينا
يا كربة النفس للإسلام ما صنعت بكل أرض به أيدي المعادينا
الأرض قد ملئت شرًّا وزلزلها جور الطغاة ولؤم المستغلينا
يا للطغاة وما أشقى الأنام بهم عاثوا قوارين أو عاثوا فراعينا
وقد يسائل الإنسان نفسه: هل الأزمة التي تعيشها الأمة اليوم من الخوف والوهن والتشتت والتشرذم هي شيء عابر أم أنها أوجاع لأمراض فكرية وسياسية ونفسية عاشتها الأمة وما زالت، وعاصرتها وما برحت وهي الآن تلفها بهول كثيف من الدواهي والفتن والزلازل؟ وما أراني وما أحسبني أميل إلى الأوهام أو المصادفات التي ربما تنطلي على الأطفال أحيانًا؛ لأن كل عمل تقابله نتيجة، وأمة ليس عندها رؤية للتجمع أو الوحدة أو الفهم والفكر الصحيح أو التعايش والتحاب أو التقدم والنهضة أو الريادة والانطلاق للمستقبل أو الاستقلال والتخلص من التبعية، أو الاستقرار على عقيدة وهوية؛ جدير بها أن تتفتت وتعيش في عواصف من الخوف وأمواج من الرعب وعدم الاستقرار، وتصبح نهبًا للاستعمار والاستغلال، لعدو بعيد يتجهمها أو قريب يملك أمرها ويسوقها بالعصا الغليظة ومقامع الحديد.
وإلا فأين أجهزة الأمة المختلفة، وأين عملها إن كانت هناك أجهزة؟ وأين نتائج تلك الأعمال وما الأسباب التي تعوقها؟!.
أين السياسة والمؤسسات السياسية: جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرهما؟ لماذا لم تحل مشاكلنا سياسيًّا؟ لماذا لا تعتبر هذه المؤسسات وساستها أن مشاكل الأمة مهما كانت عويصة تحدٍّ يجب الانتصار عليها؛ لأن استقرار الأمة واقتصادها ومستقبلها وهويتها وانطلاقها مرهون بها؟ لماذا تكون السياسة عند بعضنا نوعًا من التبعية ورعاية مصالح الخصوم؟ ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن السياسة في الأمة قد جذرت العديد من المشاكل وجعلتها غير قابلة للحل، حتى صارت طبيعة في بعض السلطات والأجهزة الأمنية على السواء، وقد تعدَّى ضررها إلى الغير، ونحن نرى ذلك اليوم: سياسة ضلَّت الطريق، ففرَّغت المؤسسات من الرؤى الصائبة والنظرة المخلصة المستقلة، وعميت حتى جعلت الصديق عدوًّا والعدو صديقًا!.
ثم لماذا لا يقوم المثقفون في الأمة بالدور المطلوب منهم، بل أين أصحاب الفكر في الأمة؟ وأين الكتَّاب والمفكرون وأصحاب الرأي والمكانة في المجتمعات؟ لمَ لم يؤلفوا الوفود ويذهبوا هنا وهناك؛ لتقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء لجمع شمل الأمة وقيامها بما ينبغي عليها؟ أين علماء الأمة؟ أين الأزهر والزيتونة والجامعات وأساتذتها؟ لماذا لا يقفون صفًّا مع الأمة، ويكونون نصَّاحًا ومرشدين ومعضدين للسلطات بالرأي السديد؟ أين الأحزاب الوطنية والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية وغير الطلابية؟ بل أين أدوار المرأة الوطنية؟!.
لا أظن أن أحدًا من الساسة أو المفكرين والعلماء والمثقفين بعيدو اللوم أو المؤاخذة فيما وصلت إليه أحوال هذه الأمة.
إن الصحافة والمجلات والإذاعات والتلفازات والقنوات الفضائية في إمكانها أن تفعل الكثير في تنبيه الأمة من الخطر المحدق بها، وفي كشف الكثير من الأضاليل والترهات التي يقصد بها التوهين وقتل الطاقات والتعمية على الإصلاح والإصلاحيين، وما تقوم هذه الأدوات إلا بجهد المثقفين وفكر العلماء والمتخصصين، ولماذا لا يكون هناك بعض التضحيات من الامتناع مثلاً ولا نقول الإضراب عن بعض الأبواق والقنوات التي لا تخدم الأمة ولا تصب في مصلحتها وحمل رسالتها؟!.
ما قيد الفكر منَّا جور طاغية أو أوهن العزم بطش المستبدينا
غرامنا الحق لم نقبل به بدلاً إن غيَّرت غِيرُ الدنيا المحبينا
في الخوف والأمن ما زاغت مواقفنا والعسر واليسر قد كنَّا ميامينا
وأقول بعد ذلك: لا بد لنا من إيمان أكرر إيمان إيمان بالله.. إيمان بالرسالة.. إيمان بالعدالة.. فهذا هو العاصم، وهذا هو الصدق وملاك الصادقين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15)﴾ (الحجرات).
وأقولها صريحة داوية: إذا أراد المسلمون أن يكونوا أمة مجد كما كانوا، أمة عزٍّ كما عرفوا، لا بد أن يولد المسلم ولادةً جديدةً من عقيدته، لا من رحم أمه، وينبعث من معرفته بالله وحرارة إيمانه بربه، وتصديقه بوعده ووعيده، عملاقًا شامخًا، يرتفع ببصره ويعلو بأمله ويسمو بواقعه فوق هذه الدنيا، وفوق عبَادتها الذين يظنون أنهم قادرون على محو الإسلام والمسلمين، وصدق الله: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (

﴾ (الصف)، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21)﴾ ( يوسف: من الآية 21).




 الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:04 am
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:04 am